
الأخلاق | سي إس لويس
أقسام الأخلاق الثلاثة هناك قصة عن تلميذ في مدرسة سُئل عمّا يظنّه عن الله. فأجاب
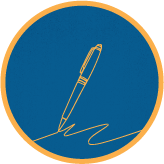
هناك قصة عن تلميذ في مدرسة سُئل عمّا يظنّه عن الله. فأجاب بأنّ الله، كما يبدو له، هو ”ذلك الكائن الذي يتلصّص دائمًا ليرى إن كان أحد يستمتع بشيء، ثم يحاول أن يمنعه.” وأخشى أن هذه الفكرة بالذات هي ما يخطر في ذهن الكثيرين حين يسمعون كلمة ”الأخلاق“؛ شيء يتدخل، شيء يمنعك من الاستمتاع. لكن في الحقيقة، القواعد الأخلاقية ما هي إلاّ تعليمات لتسيير ”الآلة الإنسانية“. فكل قاعدة أخلاقية موجودة لتمنع عطلًا أو خللًا أو احتكاكًا في سير هذه الآلة. ولهذا تبدو هذه القواعد في البداية وكأنها تتعارض دائمًا مع ميولنا الطبيعية. حين تتعلَّم استخدام أي آلة، يظلَّ المدرّب يكرر لك: ”لا، لا تفعلها بهذه الطريقة“، لأن هناك أمورًا كثيرة تبدو صحيحة أو طبيعية في نظرك للتعامل مع الآلة، لكنها في الحقيقة لا تعمل.

بعض الناس يفضلون أن يتحدثوا عن ”المُثُل الأخلاقية“ بدلًا من ”القواعد الأخلاقية“، وعن ”المثالية الأخلاقية“، بدلًا من ”الطاعة الأخلاقية“. صحيح أن الكمال الأخلاقي هو ”مثل أعلى“ من حيث إننا لا نستطيع بلوغه. بهذا المعنى، كل نوع من الكمال بالنسبة لنا نحن البشر هو ”مثل أعلى“: فلا يمكننا أن نكون سائقي سيارات مثاليين، أو لاعبي تنس مثاليين، أو أن نرسم خطوطًا مستقيمة تمامًا. لكن من جهة أخرى، من المضلِّل أن نعتبر الكمال الأخلاقي مجرد ”مثل أعلى“. فحين يقول شخص إن امرأةً معينة، أو بيتًا، أو سفينة، أو حديقة هي ”مثله الأعلى“، فهو لا يعني (إلاّ إذا كان ساذجًا) أن على الجميع أن يكون لهم نفس المثل الأعلى. في مثل هذه الأمور، يحق لنا أن نختلف في الأذواق وبالتالي في المُثل. لكن من الخطير أن نصف الرجل الذي يجتهد كثيرًا في حفظ الشريعة الأخلاقية بأنه ”رجل ذو مثل عالية“، لأن هذا قد يقودنا إلى التفكير في أن الكمال الأخلاقي مجرد ذوق شخصي خاص به، ولسنا نحن جميعًا ملزمين به. وهذا خطأ فادح. فالسلوك الكامل قد يكون غير قابل للتحقيق مثل تغيير التروس بدقة تامة، أثناء القيادة؛ لكنه مع ذلك هو مثل لازم لكل البشر بحسب طبيعة الآلة الإنسانية نفسها، تمامًا كما أن تغيير التروس بدقة هو مثل لازم لكل السائقين بحسب طبيعة السيارات. بل من الأخطر أن يظن الإنسان نفسه صاحب ”مثل عالية“ لأنه يحاول ألا يكذب مطلقًا (بدلًا من أن يكذب قليلًا فقط)، أو لا يزني أبدًا (بدلًا من أن يزني نادرًا)، أو لا يتجبّر على أحد (بدلًا من أن يكون متجبرًا باعتدال). هذا التفكير قد يجعله مغرورًا، متوهمًا أنه شخص مميز يستحق التهنئة على ”مثاليته“. بينما في الواقع لا يختلف ذلك عن توقع التهنئة لمجرد أنك حين تحل مسألة رياضية تحاول أن تأتي بالجواب الصحيح تمامًا. صحيح أن الحساب الدقيق هو ”مثل أعلى“؛ فمن المؤكد أنك سترتكب بعض الأخطاء. لكن لا يوجد ما يدعو للافتخار لمجرد أنك تحاول أن تكون دقيقًا في كل خطوة؛ بل سيكون غباءً ألا تحاول ذلك، لأن كل خطأ سيسبب لك مشكلة لاحقًا. وبالمثل، كل فشل أخلاقي سيسبب مشاكل، غالبًا للآخرين وبالتأكيد لك. وحين نتحدث عن القواعد والطاعة بدلًا من ”المثل” و”المثالية“، فإننا نساعد أنفسنا على تذكُّر هذه الحقائق.
والآن لنذهب أبعد قليلًا. هناك طريقتان تنحرف بهما الآلة الإنسانية. الأولى: حين ينفصل الناس عن بعضهم أو يصطدمون ويضر بعضهم بعضًا بالغش أو الظلم. الثانية: حين يختل النظام داخل الفرد نفسه – حين تتنافر أجزاؤه المختلفة أو تتدخل في عمل بعضها. لتوضيح ذلك، تخيّلنا كأسطول سفن يُبحر في تشكيل واحد، لا ينجح هذا الإبحار إلا إذا، أولًا، لم تصطدم السفن ببعضها ولم تعرقل طريق بعضها، وثانيًا، كانت كل سفينة صالحة للإبحار ومحركاتها تعمل جيدًا. وفي الواقع لا يمكن تحقق أحد الأمرين دون الآخر. فإن كانت السفن كثيرًا ما تتصادم، فلن تبقى صالحة للإبحار طويلًا. وإن كان جهاز التوجيه في خلل، فلن تستطيع تجنب التصادم. أو، إن شئت، تخيّل البشرية كفرقة موسيقية تعزف لحنًا، لا يخرج الأداء جيدًا إلا إذا كان كل عازف قد ضبط آلته، ودخل في الوقت الصحيح لينسجم مع الآخرين.
لكن هناك أمرًا آخر لم نحسب حسابه: لم نسأل إلى أين يتَّجِه الأسطول أصلًا؟ أو أي قطعة موسيقيَّة تحاول الفرقة أن تعزفها؟ فقد تكون الآلات كلها منسجمة، ويدخل كل عازف في الوقت المضبوط، ومع ذلك يفشل الأداء إن كانوا متعاقدين على عزف موسيقى رقص بينما لم يعزفوا إلاَّ ألحانًا جنائزية. وكذلك مهما كان إبحار الأسطول منظمًا، سيُعدّ فاشلًا إن كان المقصود أن يصل إلى نيويورك فإذا به يصل إلى كالكوتا.
إذًا، الأخلاق تبدو معنية بثلاثة أمور: أولًا، بالعدل والانسجام بين الأفراد. ثانيًا، بترتيب وتناغم ما هو في داخل كل فرد. ثالثًا، بالغاية العامة من حياة الإنسان كلها: لماذا وُجد الإنسان؟ وما الوجهة التي يجب أن يسلكها الأسطول؟ وما اللحن الذي يريد قائد الفرقة أن يُعزَف؟
لعلك لاحظت أن الناس في عصرنا يكادون دائمًا يفكرون في الأمر الأول وينسون الاثنين الآخرين. حين تقول الصحف إننا نسعى إلى “المعايير الأخلاقية المسيحية“، فإنهم غالبًا يقصدون أننا نسعى إلى اللطف والعدل بين الأمم والطبقات والأفراد؛ أي إنهم يفكرون فقط في الأمر الأول. وحين يقول شخص عن شيء يريد فعله: ”لا يمكن أن يكون خطأ ما دام لا يؤذي أحدًا“، فإنه يفكر فقط في الأمر الأول. يفكر وكأن لا يهم إن كانت سفينته صالحة من الداخل ما دام لم يصطدم بالسفينة الأخرى. ومن الطبيعي حين نبدأ التفكير في الأخلاق أن نبدأ بالعلاقات الاجتماعية. فنتائج الفساد الأخلاقي هناك واضحة وضاغطة علينا يوميًا: الحرب والفقر والرشوة. وأيضًا، ما دمنا متمسكين بالأمر الأول، لا يوجد خلاف كبير على الأخلاق؛ فكلّ البشر تقريبًا، في كل الأزمان، اتفقوا (نظريًّا) على أن الإنسان ينبغي أن يكون صادقًا ولطيفًا ومعاونًا. لكن لو توقفنا عند هذا فقط، فكأننا لم نفكر مطلقًا. فلا بد أن نكمل إلى الأمر الثاني – تنظيم ما في داخل الإنسان – وإلا خدعنا أنفسنا.
فما الفائدة من تعليم السفن كيف تتجنب التصادم إن كانت في الواقع سفنًا مهترئة لا يمكن قيادتها؟ وما الفائدة من وضع قواعد للسلوك الاجتماعي على الورق، إن كنا نعلم أن شجعنا وجبننا وسوء طبعنا وكبرياءنا ستمنعنا من الالتزام بها؟ لا أقصد أننا لا ينبغي أن نفكر، وبجدية، في تحسين أنظمتنا الاجتماعية والاقتصادية؛ بل أقصد أن هذا التفكير كله سيكون عبثًا إن لم ندرك أن لا شيء سوى شجاعة الأفراد وإيثارهم يمكن أن يجعل أي نظام يعمل كما ينبغي. فمن السهل إزالة أشكال الفساد أو الظُلم القائمة في النظام الحالي، لكن ما دام البشر ماكرين أو متجبرين، سيجدون طريقة جديدة لممارسة نفس اللعبة تحت أي نظام جديد. لا يمكنك أن تجعل الناس صالحين بالقانون؛ وبدون أناس صالحين لا يمكن أن تكون هناك جماعة صالحة. لهذا يجب أن نفكر في الأمر الثاني: الأخلاق داخل الفرد.
لكن لا يمكن أن نتوقف هناك أيضًا. هنا نصل إلى النقطة التي تؤدي فيها معتقدات مختلفة عن الكون إلى سلوك مختلف. وقد يبدو منطقيًا أن نتوقف قبل الوصول إلى هذه المرحلة، ونكتفي بتلك الأجزاء من الأخلاق التي يتفق عليها جميع العقلاء. لكن هل نستطيع؟ تذكّر أن الدين يتضمن سلسلة من التصريحات عن “حقائق“ لا بد أن تكون صحيحة أو خاطئة. فإن كانت صحيحة، ستترتب عليها نتائج معينة بشأن سير الأسطول البشري؛ وإن كانت خاطئة، ستترتب نتائج أخرى مختلفة. على سبيل المثال، فلنعد إلى الرجل الذي يقول إن الشيء لا يكون خطأ إلا إن أضرّ بإنسان آخر. إنه يفهم جيدًا أنه لا ينبغي له أن يضر بالسفن الأخرى في القافلة، لكنه يظن بصدق أن ما يفعله بسفينته شأن يخصه وحده. لكن ألاَ يختلف الأمر كثيرًا إن كانت هذه السفينة مِلكه الخاص فعلًا أم لا؟ ألا يختلف الأمر كثيرًا إن كنت أنا، إن جاز التعبير، مالكًا حقيقيًا لعقلي وجسدي، أم مجرد مستأجر مسؤول أمام المالك الحقيقي؟ فإذا كان شخص آخر قد خَلَقَني لأجل مقاصده، عندها ستكون عليّ التزامات كثيرة لم تكن لتوجد لو أنني أنتمي إلى نفسي فقط.
مرة أخرى، تعلن المسيحية أن كل إنسان فرد سيحيا إلى الأبد، وهذه الحقيقة لا بد أن تكون صحيحة أو خاطئة. هناك أشياء كثيرة لن يكون لها قيمة كبيرة إن كانت حياتي لا تتجاوز السبعين عامًا، لكنها تستحق اهتمامًا بالغًا إن كنت سأحيا إلى الأبد. ربما مزاجي السيئ أو غيرتي يتفاقمان تدريجيًا -حتى لو كان هذا التفاقم غير ملحوظ في سبعين سنة، لكنه قد يصبح جحيمًا مطلقًا بعد مليون سنة. وفي الواقع، إن كانت المسيحية صحيحة، فالجحيم هو المصطلح التقني الدقيق لما سيكون عليه الأمر. والخلود يضيف فرقًا آخر يرتبط بالفرق بين الشمولية والديمقراطية. إن عاش الإنسان سبعين سنة فقط، فالدولة أو الأُمّة أو الحضارة التي قد تَدوم ألف سنة تكون أهم من الفرد. أمّا إن كانت المسيحية صحيحة، فالفرد ليس أهم فقط، بل لا يُقارَن أهميته بغيره، لأنه خالد، وحياة دولة أو حضارة بالمقارنة معه ليست إلاّ لحظة.
إذن، إن أردنا التفكير في الأخلاق، علينا أن نفكر في الأقسام الثلاثة جميعًا: العلاقات بين إنسان وإنسان، الأمور الداخلية لكل إنسان، والعلاقة بين الإنسان والقوة التي خلقته. يمكننا جميعًا التعاون في القسم الأول. تبدأ الخلافات مع القسم الثاني، وتزداد خطورتها في القسم الثالث. ومع القسم الثالث تحديدًا تظهر الفروق الجوهرية بين الأخلاق المسيحية وغير المسيحية. وفي بقية هذا العمل؛ [المسيحية المجردة]، سأفترض وجهة النظر المسيحية، وأنظر إلى الصورة الكاملة كما ستكون إن كانت بالفعل المسيحية صحيحة.
كان القسم السابق مكتوبًا أصلًا ليلقى كحديث إذاعي قصير. وحين يكون مسموحًا لك بالكلام لعشر دقائق فقط، فلا بد أن يُضحَّى بالكثير من التفاصيل من أجل الإيجاز. وأحد الأسباب الرئيسة التي دفعتني إلى تقسيم الأخلاق إلى ثلاثة أجزاء (بمثال السفن المبحرة في قافلة) هو أنّ ذلك بدا لي أقصر طريق لتغطية الموضوع. أمّا هنا فأريد أن أقدِّم تصورًا آخر قدّمه الكُتّاب القدماء، أطول من أن يُستخدم في محاضرة إذاعية، لكنه تقسيم جيّد وذو قيمة.
وفقًا لهذا التصوّر الأوسع، هناك سبع فضائل، أربع منها تُسمّى الفضائل الأساسية، والثلاث الباقية تُسمّى الفضائل اللاهوتية. الفضائل الأساسية هي تلك التي يعترف بها كل الشعوب المتحضّرة؛ أمّا اللاهوتية فعادةً ما يعرفها المسيحيون وحدهم. سأؤجل الحديث عن اللاّهوتية لاحقًا، وأتناول الآن الأربع الأساسية أو الكارديناليّة (كلمة كاردينال Cardinal لا علاقة لها بمناصب الكرادلة في الكنيسة الكاثوليكية، بل أصلها من الكلمة اللاتينية Cardo أي ”المِفصَل“ أو ”مِحور الباب“، وسُمّيت هكذا لأنها فضائل محورية أو أساسية). هذه الفضائل هي: الحِكمة العمليّة أو التعقّل Prudence، والاعتدال Temperance، والعدل Justice، والثبات أو الشجاعة Fortitude.
أولاً: التعقُّل Prudence تعني الحسّ السليم العملي، أي أن يُتعب المرء نفسه في التفكير عمّا يفعله وما قد يترتب عليه. في أيامنا، قلّما يُعدّ الناس التعقّل واحدة من الفضائل. بل إنّ بعض المسيحيين يتوهمون، لأن المسيح قال إننا لا ندخل ملكوته إلاّ إن صرنا كالأطفال، أنّه يكفي أن تكون صالحًا حتى ولو كنت غبيًّا. لكن هذا فهم خاطئ. فأولًا: معظم الأطفال يُظهِرون قدرًا من التعقّل فيما يهمّهم فعلًا، ويفكرون فيه بعقلانية. وثانيًا: كما يوضح القديس بولس، المسيح لم يقصد أن نظل أطفالًا في الذكاء، بل العكس. فقد أوصانا أن نكون ”بسطاء كالحمام“ لكن أيضًا ”حكماء كالحيات“. يريد المسيح قلبًا طفلًا، لكن عقلًا ناضجًا. يريدنا أن نكون بسطاء، مخلصين، قابلين للتعلّم، كما الأطفال الصالحين، لكنّه أيضًا يريد أن يعمل كل جزء من عقلنا بكامل طاقته. فمجرد أنك تتبرع لمؤسسة خيرية لا يعفيك من التحقُّق إن كانت تلك المؤسسة حقيقية أم أنّ في الأمر احتيالًا. ومجرد أنك تفكر في الله حين تصلّي لا يبرِّر أن تكتفي بأفكار طفولية كنت تؤمن بها في سن الخامسة. صحيح أن الله لا يحبك أقل إن كنت ذا عقل ضعيف أو لم تُولد بذكاء مُتَّقِد؛ لكنّه يطلب منك أن تستخدم العقل الذي لديك قدر استطاعتك. الشعار الصحيح ليس: ”كوني طيبة، يا فتاة، ودعي الذكاء لمن يستطيع أن يكون ذكيًّا بل: ”كوني طيبة، يا فتاة، ولا تنسي أن الطيبة الحقيقية تعني أيضًا أن تمارسي الذكاء قدر ما تستطيعين.“ الله لا يحب الكسل العقلي أكثر مما يحب الكسل في أي مجال آخر. أن تكون مسيحيًا هو أمر يتطلب كلك – قلبك، وعقلك أيضًا. لكن لحسن الحظ، العكس صحيح أيضًا: فكل من يحاول بصدق أن يعيش كمسيحي يجد أن عقله يتفتّح ويصير أكثر حدّة. المسيحية بحد ذاتها تعليم وتربية. ولهذا استطاع مؤمن غير متعلّم مثل جون بُنيان أن يكتب كتابًا أدهش العالم كلّه.
ثانيًا: الاعتدال Temperance كلمة تغيّر معناها مع الزمن. اليوم تُستخدم غالبًا بمعنى الامتناع الكلّي عن الخمر. لكن عند إطلاقها كاسم للفضيلة الثانية، لم تكن تعني هذا. فالاعتدال لا يختص بالشراب وحده، بل يشمل كل الملذّات. كما لا تعني الامتناع، بل أن نأخذ منها القدر الصحيح وألا نتجاوز الحد. ليس صحيحًا أن المسيحيين يجب أن يكونوا جميعًا ممتنعين تمامًا عن الكحوليات؛ الإسلام هو الدين الذي فرض الامتناع الكامل، لا المسيحية. ومع ذلك، قد يكون واجبًا على مسيحي بعينه أن يمتنع عن الكحوليات: إمّا لأنه يعلم أن طبيعته تجعله يُسرف لو شرب، أو لأنه بين أشخاص يميلون إلى السكر ولا يجوز أن يشجعهم بشربه. لكن المهم هنا أن امتناعه ليس لأنه يحتقر الكحوليات أو يدينها، بل لأنه يحبها ويقدّرها، ومع ذلك يمتنع لسبب صالح. إحدى علامات الشخص الرديء أنه إذا امتنع عن أمر، أراد أن يُجبر الجميع على الامتناع عنه أيضًا. أما الروح المسيحية فهي مختلفة. فقد يختار المؤمن أن يتخلَّى عن الزواج، أو اللَّحم، أو الشَّراب، أو السينما لأسباب خاصة، لكن حين يبدأ بالقول إن هذه الأشياء شريرة في ذاتها، أو يحتقر الآخرين الذين يستعملونها، يكون قد انحرف عن الطريق. ومن أضرار حصر معنى الاعتدال في الشراب فقط أنه يجعل الناس ينسون أن الانغماس قد يكون في أشياء كثيرة أخرى: في رياضة، أو في هواية، أو في الملابس، أو في الكلاب، أو في لعبة الورق. شخص يجعل الجولف أو الدرَّاجة النارية مركز حياته، أو امرأة لا يشغل عقلها إلاَّ مظهرها أو كلبها، هم لا يقلِّون إسرافًا عن سكير يسقط كل ليلة في الطريق. قد لا يظهر ذلك للخارج بسهولة، لكنه في نظر الله لا يختلف.
ثالثًا: العدل Justice لا يقتصر على ما يحدث في المحاكم. هو الاسم القديم لما نسمّيه الآن ”الإنصاف“ ويشمل الأمانة، وتبادل الحقوق، والصدق، والوفاء بالوعود، وكل ما يَتَّصِل بهذا الجانب من الحياة.
رابعًا: الثبات أو الشجاعة Fortitude يعني نوعين من الشجاعة: الشجاعة في مواجهة الأخطار، والشجاعة في تحمّل وطأة الألم. والكلمة الأقرب اليوم ربما هي ” العزيمة” Guts ومن الواضح أنك لا تستطيع ممارسة أي من الفضائل الأخرى طويلًا دون أن تُستدعى هذه الفضيلة.
من المهم أن نلاحظ الفرق بين أن يقوم الإنسان بعمل عادل أو معتدل مرة، وبين أن يكون إنسانًا عادلًا أو معتدلًا. فاللاَّعب غير الماهر قد يسدِّد كُرة رائعة أحيانًا، لكن اللاَّعب الجيِّد هو من صارت عيناه وعضلاته مدرَّبة على ذلك حتى غدا يمكن الاعتماد عليه دائمًا. الأمر نفسه مع الرياضيات: عقل الرياضي يحتفظ بعاداته حتى حين لا يمارس الحساب. وبالمثل، الإنسان الذي يداوم على الأفعال العادلة يكتسب في النهاية صفة راسخة في شخصيته. وهذه الصفة الراسخة هي ما نقصده حين نقول “فضيلة“، وهي ما يتجاوز مجرد الأفعال الفردية.
لو ركزنا فقط على الأفعال، قد نقع في ثلاثة أخطاء. قد نظن أن المهم هو الفعل الصحيح فقط، بغض النظر عن الدافع: هل فعلته بفرح أم بتذمّر؟ بخوف من الناس أم بحب الحق نفسه؟ لكن الأفعال الصحيحة بدوافع خاطئة لا تبني في الداخل تلك الصفة الراسخة التي تُدعى فضيلة. مثل لاعب التنس السيء الذي يُسَدِّد ضربة قوية بدافع غضبه، قد يربح النقطة بالصدفة لكنه لا يصبح لاعبًا أفضل. وقد نظن أن الله يريد فقط طاعة لقوانين؛ بينما هو يريد أن نصير أُناسًا من نوع معيّن. وقد نظن أن الفضائل مطلوبة فقط في هذه الحياة، وأنه في العالم الآخر لن يكون هناك حاجة للعدل لأنه لا خصام، ولا للشجاعة لأنه لا خطر. لكن الحقيقة أن ما سيبقى هناك هو تلك النوعية الداخلية التي نكتسبها هنا عبر هذه الأفعال. ليست المسألة أن الله يرفض دخولك إلى السماء إن لم تكتسب هذه الصفات؛ بل المسألة أنك إن لم تكن تحمل بذورها في داخلك، فلن تستطيع أي ظروف خارجية أن تجعلك سعيدًا بذلك الفرح العميق الراسخ الذي أعدّه الله لنا.
أول ما ينبغي أن يكون واضحًا بخصوص الأخلاق المسيحية بين إنسان وآخر هو أن المسيح في هذا الجانب لم يأتِ ليُعلن أخلاقًا جديدة تمامًا. إن القاعدة الذهبية في العهد الجديد؛ “افعل بالآخرين ما تريد أن يفعلوه بك”، هي مجرد تلخيص لما عرفه الجميع في أعماقهم دائمًا أنه صواب. المعلمون الأخلاقيون العظام لم يقدّموا أبدًا أخلاقًا جديدة، بل الدجّالون والمهووسون هم من يفعلون ذلك. وكما قال د. جونسون: ”الناس يحتاجون إلى التذكير أكثر مما يحتاجون إلى التعليم“. فالمهمة الحقيقية لكل معلم أخلاقي هي أن يعيدنا مرارًا وتكرارًا إلى المبادئ القديمة البسيطة التي نميل جميعًا إلى تجاهلها؛ مثلما تعيد الحصان المرة تلو الأخرى إلى السور الذي رفض أن يقفز فوقه، أو الطفل إلى الجزء من درسه الذي يصر على التهرب منه.
الأمر الثاني الذي ينبغي توضيحه هو أن المسيحية لا تملك، ولم تدَّعِ يومًا أنها تملك، برنامجًا سياسيًا تفصيليًّا لتطبيق قاعدة ”افعل بالآخرين ما تريد أن يفعلوه بك“ في مجتمع معيّن في لحظة معيّنة. فهي لا يمكن أن تملك ذلك، لأنها موجّهة لكل البشر في كل الأزمنة، والبرنامج الذي يناسب مكانًا أو زمانًا قد لا يناسب آخر. وعلى أية حال، هذه ليست طريقة عمل المسيحيَّة. فهي حين تأمرك أن تُطعِم الجائع لا تعطيك دروسًا في فن الطهي. وحين تأمرك أن تقرأ الكتب المقدسة لا تعطيك دروسًا في العبرية واليونانية، ولا حتى في قواعد اللغة الإنجليزية. لم يكن المقصود أن تحل المسيحية محل الفنون والعلوم البشرية، بل أن تكون بمثابة الموجِّه الذي يوجّهها إلى وظائفها الصحيحة، ومصدر طاقة يمنحها حياة جديدة إذا وضعت نفسها تحت تصرفها.
يقول الناس: ”ينبغي للكنيسة أن تقودنا“. وهذا صحيح إذا قصدوا به المعنى السليم، لكنه خطأ إذا قصدوا به المعنى الخاطئ. فالمقصود بالكنيسة هو جماعة المسيحيين الذين يمارسون إيمانهم، وحين يقال إن على الكنيسة أن تقود، ينبغي أن يُفهم أن بعض المسيحيين – ممن لديهم المواهب المناسبة – ينبغي أن يكونوا اقتصاديين ورجال دولة، وأن يكون جميع الاقتصاديين ورجال الدولة مسيحيين، وأن يوجّهوا كل جهودهم في السياسة والاقتصاد إلى تطبيق قاعدة ”افعل بالآخرين ما تريد أن يفعلوه بك“. ولو حدث ذلك، وكنا نحن الآخرون مستعدين فعلًا لتقبله، لوجدنا الحل المسيحي لمشاكلنا الاجتماعية سريعًا. لكن بالطبع، حين يطلب الناس قيادة من الكنيسة، فإنهم غالبًا يقصدون أنهم يريدون من الإكليروس أن يضعوا برنامجًا سياسيًّا. وهذا غباء. فالإكليروس هم أولئك الذين تدرّبوا خصيصًا وتفرّغوا للاعتناء بما يخصنا ككائنات ستعيش إلى الأبد، بينما نطلب منهم أن يقوموا بعمل آخر تمامًا لم يتدرّبوا عليه. المهمة الحقيقية تقع على عاتقنا نحن، العلمانيين. فتطبيق المبادئ المسيحية مثلًا على النقابات العمالية أو التعليم، يجب أن يأتي من نقابيين مسيحيين ومعلمين مسيحيين، تمامًا كما أن الأدب المسيحي يأتي من روائيين ومسرحيين مسيحيين، لا من مجلس الأساقفة حين يجتمعون ويحاولون كتابة روايات ومسرحيات في أوقات فراغهم.
ومع ذلك، فإن العهد الجديد، من دون الدخول في التفاصيل، يعطينا تلميحًا واضحًا عن شكل المجتمع المسيحي الكامل. ربما يعطينا أكثر مما نحتمل. فهو يقول إن لا مكان للمتطفلين أو الكسالى؛ ”إن كان أحد لا يعمل فلا يأكل أيضًا.“ كل إنسان يجب أن يعمل بيديه، بل وأن ينتج عمله شيئًا نافعًا. فلن يكون هناك صناعة تافهة للترف السخيف، ولا دعايات أكثر تفاهة لإقناعنا بشرائه. ولن يكون هناك تكبّر أو استعلاء. إلى هذا الحد، قد يُعتبر المجتمع المسيحي مجتمعًا يساريًا. ومن ناحية أخرى، هو يصرّ دائمًا على الطاعة: طاعة (مع علامات خارجية من الاحترام) من الجميع للقضاة المعيّنين شرعًا، ومن الأطفال للوالدين، ومن الزوجات للأزواج – وأنا أعلم أن هذا الأمر الأخير لن يلق قبول الكثيرين.
الأمر الثالث، يجب أن يكون المجتمع مُبْهِجًا: مليئًا بالترانيم والفرح، ويعتبر القلق أو الانشغال خطأ. الأدب من الفضائل المسيحية؛ والعهد الجديد يكره من يسميهم ”المتطفلين“.
ولو وُجد مثل هذا المجتمع وزرناه، لخرجنا بانطباع غريب. سنشعر أن حياته الاقتصادية اشتراكية جدًا ومتقدمة، لكن حياته العائلية وقواعد سلوكه أشبه بالقديمة – وربما حتى رسمية وأرستقراطية. كل واحد منّا سيعجبه جانب منه، لكن أخشى أن القليلين فقط سيعجبهم الكل. وهذا ما نتوقعه إذا كانت المسيحية هي المخطط الكامل للآلة الإنسانية. لقد انحرفنا جميعًا عن هذا المخطط الكامل بطرق مختلفة، وكل واحد يريد أن يقنع نفسه أن تعديله الخاص هو المخطط الأصلي نفسه. وهذا ما يتكرر مع كل ما هو مسيحي بحق: كل إنسان ينجذب إلى بعض أجزائه ويريد أن يحتفظ بها ويترك الباقي. ولهذا لا نتقدم كثيرًا؛ ولهذا أيضًا يمكن لأشخاص يقاتلون من أجل أمور متناقضة تمامًا أن يقولوا إنهم يقاتلون من أجل المسيحية.
هناك نقطة أخرى. نصيحة قديمة أوصانا بها اليونان الوثنيون، واليهود في العهد القديم، والمعلمون المسيحيون في القرون الوسطى، وقد خالفها النظام الاقتصادي الحديث تمامًا: جميعهم أوصونا بألا نقرض المال بفائدة. لكن إقراض المال بفائدة – ما نسميه الاستثمار – هو أساس نظامنا كله. قد لا يكون هذا خطأ بالضرورة. فهناك من يقول إن موسى وأرسطو والمسيحيين حين منعوا الفائدة أو الربا، لم يكن في بالهم الشركات المساهمة، بل فقط المرابي الفردي، وبالتالي لسنا ملزمين بما قالوه. هذا سؤال لا أستطيع أن أجيب عنه. لست اقتصاديًا ولا أعرف إن كان نظام الاستثمار مسؤولًا عن حالنا أم لا. هنا نحتاج إلى الاقتصادي المسيحي. لكن لم أكن لأكون أمينًا إن لم أقل إن ثلاث حضارات عظيمة قد اتفقت (أو هكذا يبدو) على إدانة الشيء نفسه الذي بنينا عليه حياتنا كلها.
أمرٌ أخير. في المقطع الذي يقول فيه العهد الجديد إن على كل إنسان أن يعمل، يعطي السبب: ”لكي يكون له ما يعطيه للمحتاجين.“ العطاء للفقراء جزء جوهري من الأخلاق المسيحية: في مثل الخراف والجداء المخيف، يبدو أنه النقطة التي يتوقف عليها كل شيء. بعض الناس اليوم يقولون إن العطاء ينبغي أن يكون غير ضروري، وأننا بدلًا من إعطاء الفقراء يجب أن ننتج مجتمعًا لا يوجد فيه فقراء أصلًا. قد يكونون محقين في أن علينا أن نسعى لمثل هذا المجتمع. لكن إن ظن أحد أنه كنتيجة لذلك يمكنه أن يتوقَّف عن العطاء في الوقت الحالي، فقد انقطع عن كل الأخلاق المسيحية. لا أظن أن بإمكان أحد أن يحدد كم ينبغي أن نعطي. أخشى أن القاعدة الآمنة الوحيدة هي أن نعطي أكثر مما نستطيع الاستغناء عنه. بمعنى آخر، إذا كان إنفاقنا على الراحة والترف والتسلية مساويًا للمستوى السائد بين من يملكون نفس دخلنا، فغالبًا ما نقدمه قليل جدًا. إن لم يكن عطاؤنا يضيّق علينا أو يحرمنا من شيء، فهو غالبًا صغير. ينبغي أن تكون هناك أمور نرغب أن نفعلها ولا نستطيع، لأن مصروفاتنا على العطاء تمنعنا منها. وأنا هنا أقصد ”الأعمال الخيرية“ بالمعنى الشائع. أما الحالات الخاصة من الضيق بين الأقارب أو الأصدقاء أو الجيران أو الموظفين، التي يضعها الله أمامنا، فقد تطلب أكثر بكثير: حتى إلى حد إضعاف مركزنا أو تعريضه للخطر. بالنسبة للكثيرين منّا، العقبة الكبرى أمام العطاء ليست في حياتنا المترفة أو رغبتنا في المال، بل في خوفنا – خوفنا من عدم الأمان. وهذا يجب أن يُعترَف به كنوع من التجربة. وأحيانًا يمنعنا كبرياؤنا أيضًا من العطاء: نميل إلى إنفاق أكثر مما ينبغي على المظاهر الخارجية للسخاء؛ مثل الإكراميات والضيافة، وأقل مما ينبغي على أولئك الذين يحتاجون فعلًا إلى مساعدتنا.
وقبل أن أنهي، سأجازف بتخمين عن أثر هذا القسم على القارئ. أظن أن هناك بينكم من ذوي الميول اليسارية من أغضبهم أنه لم يذهب أبعد في ذلك الاتجاه، ومن الجهة المقابلة من أغضبهم لأنه ذهب بعيدًا جدًا. وإن كان الأمر كذلك، فهذا يعيدنا إلى المشكلة الحقيقية في رسم مخطط لمجتمع مسيحي. فمعظمنا لا يقترب من الموضوع لكي يعرف ما تقوله المسيحية فعلًا، بل لكي يجد تأييدًا من المسيحية لآراء حزبه الخاص. نحن نبحث عن حليف بينما يُعرَض علينا إمّا سيد أو قاضٍ. وأنا نفسي كذلك. هناك أجزاء في هذا القسم كنت أودّ أن أتركها. ولهذا السبب لن ينتج عن مثل هذه الأحاديث شيء ما لم نأخذ الطريق الأطول. فالمجتمع المسيحي لن يتحقق حتى نرغب فيه حقًا، ولن نرغب فيه حتى نصبح مسيحيين تمامًا. قد أكرر قاعدة ”افعل بالآخرين ما تريد أن يفعلوه بك“ حتى يُبحّ صوتي، لكن لن أستطيع تنفيذها حقًا إلا إذا أحببت قريبي كنفسى. ولن أتعلم محبة قريبي كنفسى إلاّ إذا تعلمت محبة الله. ولن أتعلم محبة الله إلا إذا تعلمت طاعته. وهكذا، كما حذرتكم، نحن مدفوعون إلى شيء أعمق – من الأمور الاجتماعية إلى الأمور الدينية. فالطريق الأطول هو أقصر طريق إلى البيت.
علينا الآن أن نتأمل الأخلاق المسيحية فيما يخص الجنس، أي ما يسميه المسيحيون فضيلة العفّة. ويجب ألّا نخلط بين قاعدة العفّة المسيحية وقاعدة ”الاحتشام“ بالمعنى الاجتماعي للكلمة؛ أي اللياقة أو الأدب. فقاعدة الاحتشام تحدد مقدار ما يمكن إظهاره من الجسد، وما يجوز التطرق إليه من موضوعات، وبأي كلمات، بحسب أعراف الدائرة الاجتماعية المعينة. وهكذا، بينما تظل قاعدة العفّة واحدة لكل المسيحيين في كل الأزمنة، تتغيّر قاعدة الاحتشام. فقد تكون فتاة في جزر المحيط الهادئ التي لا ترتدي إلا القليل من الملابس، والسيدة الفيكتورية التي تغطي جسدها كله بالملابس، كلتاهما ”محتشمة“ و”لائقة“ و”مهذبة“ بحسب معايير مجتمعاتهما. وكلتاهما أيضًا، من حيث ما يوحي به المظهر، قد تكونان على قدر واحد من العفّة، أو من عدمها. بل إن بعض الألفاظ التي استعملتها النساء العفيفات في زمن شكسبير، لم تكن تُستعمل في القرن التاسع عشر إلاّ من امرأة ساقطة تمامًا.
وعندما يخالف الناس قاعدة الاحتشام السائدة في زمنهم أو مكانهم، فإن كان ذلك بغرض إثارة الشهوة في نفوسهم أو في نفوس الآخرين، فإنهم يُخطئون ضد العفّة نفسها. أمّا إذا خالفوها عن جهل أو إهمال، فإن ذنبهم لا يتعدى حدود ”سوء الأدب“، وإذا كسروا القاعدة عن قصد، بقصد صدمة الآخرين أو إحراجهم، فإن هذا ليس بالضرورة فجورًا جنسيًا، لكنه نقص في المحبة، إذ من غير المحبّة أن يجد الإنسان لذته في جعل الآخرين غير مرتاحين.
ولا أرى أن تشدُّدًا مبالغًا فيه في معايير الاحتشام أو تدقيقًا مُفرطًا بمثابة دليل على العفّة أو معين عليها. لذلك أعتبر أن التبسيط الكبير الذي طرأ على قاعدة الاحتشام في زمن حياتي أمر حسن. لكن في مرحلته الحالية يحمل هذا التبسيط إشكالية، وهي أن الناس من أعمار مختلفة وأنماط مختلفة لا يعترفون جميعًا بالمعيار نفسه، حتى صرنا لا ندري أين نقف. وطالما استمر هذا الارتباك، أرى أن على الكبار أو ”التقليديين“ أن يكونوا حذرين جدًا من الافتراض أن الشباب أو ”المتحررين“ فاسدون كلما بدا سلوكهم (بالمقياس القديم) غير لائق؛ وفي المقابل، على الشباب ألّا يصفوا الكبار بالتزمُّت أو التطهُّر لمجرد أنهم لا يتبنون المعيار الجديد بسهولة. إن الرغبة الصادقة في أن نصدّق الخير الممكن في الآخرين، والسعي في أن نجعلهم في راحة ما استطعنا، كفيلان بحل معظم هذه المشكلات.
العفّة هي أكثر الفضائل المسيحية كراهيةً لدى الناس. ولا سبيل إلى إنكار ذلك؛ فالقانون المسيحي يقول بوضوح: ”إمّا زواج، مع أمانة كاملة للشريك، أو امتناع تام.“ وهذا أمر صعب للغاية، ومناقض تمامًا لغرائزنا، حتى ليبدو أن الأمر لا يخرج عن احتمالين: إمّا أن المسيحية على خطأ، أو أن غريزتنا الجنسية، كما هي الآن، قد انحرفت. أحدهما صحيح. وبالطبع، بوصفي مسيحيًا، أعتقد أن الغريزة هي التي انحرفت.
لكن لديّ أسباب أخرى لهذا الاعتقاد. فالغاية البيولوجية من الجنس هي إنجاب الأطفال، تمامًا كما أن الغاية البيولوجية من الأكل هي ترميم الجسد. فإذا أكلنا كلما شعرنا بالرغبة وبالقدر الذي نريد، فصحيح أن أغلبنا سيأكل أكثر مما يلزم، لكن ليس بشكل فادح. قد يأكل رجل ما، ما يكفي لاثنين، لكنه لا يأكل ما يكفي لعشرة. أي إن الشهية تتجاوز قليلًا غايتها البيولوجية، لكن ليس إلى حد مبالغ فيه. أمّا إذا استسلم شاب صحيح البدن لشهوته الجنسية كلما رغب، وكان كل فعل يُنتِج طفلًا، فإنه في عشر سنوات قد يملأ قرية صغيرة بالسكان. هذه الشهوة إذن تتجاوز وظيفتها الطبيعية تجاوزًا ساخرًا ومفرطًا.
أو لنأخذ الأمر بطريقة أخرى. يمكنك أن تجمع جمهورًا كبيرًا لمشاهدة عرض تعرٍّ، أي لمجرد أن يشاهدوا فتاة تخلع ملابسها على خشبة المسرح. الآن، تخيّل أن تدخل بلدًا يمكنك أن تملأ فيه مسرحًا لمجرد أن يُقَدَّم طبق مغطَّى على الخشبة، ثم يُرفَع الغطاء ببطء ليظهر في اللحظة الأخيرة قبل انطفاء الأنوار أنه يحتوي على قطعة لحم ضأن أو شريحة من اللحم المقدّد. ألن تعتقد أن هناك خطأً ما في شهية الطعام عند شعب كهذا؟ وبالمثل، ألن يظنّ أي شخص نشأ في عالم مختلف أن هناك شيئًا غريبًا وغير سويٍّ في حالة الغريزة الجنسيَّة عندنا؟
قال أحد النقاد إنه لو وجد بلدًا تُقام فيه عروض ”تعرٍّ غذائي“ لافترض أن أهل ذلك البلد جائعون. كان قصده بالطبع أن يلمّح إلى أن مثل هذه العروض لا تنتج عن فساد جنسي بل عن ”جوع جنسي“. وأنا أتفق معه أنه لو صادفنا في بلد غريب إقبالًا على مثل هذه العروض مع قطع لحم الضأن، لكان أحد التفسيرات المحتملة التي تخطر ببالي هو المجاعة. لكن الخطوة التالية ستكون اختبار هذه الفرضية: هل يُستَهْلَك في ذلك البلد طعام كثير أم قليل؟ فإذا دلّت الأدلة على أن الطعام يُستهلك بكثرة، فعندئذٍ لا بد أن نتخلى عن فرضية ”المجاعة“ ونبحث عن تفسير آخر. وبالمثل، قبل أن نقبل فكرة ”الجوع الجنسي“ كسبب لعروض التعرِّي، علينا أن نبحث عن دليل يُثبِت أن الامتناع الجنسي في عصرنا أكثر مما كان في عصور لم تُعرَف فيها مثل هذه العروض. ولكن لا يوجد مثل هذا الدليل. فوسائل منع الحمل جعلت الانغماس الجنسي أقل كلفة داخل الزواج وأكثر أمانًا خارجه مما كان في أي وقت مضى، كما أن الرأي العام صار أقل عداءً للعلاقات غير المشروعة، بل وللانحرافات، مما كان عليه منذ العصور الوثنية. وليس “الجوع” هو التفسير الوحيد الممكن. فالكل يعرف أن الشهوة الجنسيَّة، مثلها مثل باقي شهواتنا، تنمو بالانغماس. صحيح أن الجائعين قد يفكرون كثيرًا في الطعام، لكن الشرهين كذلك؛ فالمتخمون، مثل الجوعى، يبحثون عن الإثارة.
وهنا نقطة ثالثة. نادرًا ما تجد من يرغب في أكل ما ليس بطعام، أو في استخدام الطعام في أمور غير الأكل. بمعنى أنّ الانحرافات المتعلِّقة بشهوة الطعام قليلة. أمّا الانحرافات المرتبطة بالغريزة الجنسية فهي كثيرة، وصعبة العلاج، ومُفْزِعة. يؤسفني أن أضطر للدخول في هذه التفاصيل، لكن لا بد من ذلك. والسبب هو أننا، طوال العشرين سنة الماضية، نُغذَّى يوميًا على أكاذيب صلبة متينة عن الجنس. لقد قيل لنا، حتى سئمنا سماع ذلك، إن الرغبة الجنسية لا تختلف عن أي من رغباتنا الطبيعية الأخرى، وأنه لو تخلينا عن تلك الفكرة الفيكتورية القديمة السخيفة التي تدعو إلى الكتمان، لكان كل شيء بخير. وهذا ببساطة غير صحيح. فبمجرد أن ننظر إلى الحقائق بعيدًا عن الدعاية، يتضح لنا أنه ليس كذلك.
يقولون إن الجنس صار فوضى لأنه كُبِت وكُتِم. لكن خلال العشرين عامًا الماضية لم يُكتم، بل ظل موضوعًا للثرثرة طوال النهار. ومع ذلك لا يزال في فوضى. ولو كان الكتمان هو سبب المشكلة، لكان الإفصاح قد أصلحها. لكنه لم يفعل. أظن أن العكس هو الصحيح: أعتقد أن الجنس كُبِت في الأصل لأنه كان قد صار فوضى.
الناس اليوم يردِّدون دائمًا: ”الجنس ليس شيئًا نخجل منه.“ وقد يقصدون بهذا قولين مختلفين. قد يقصدون: ”ليس هناك ما يدعو للخجل من أن الجنس البشري يتكاثر بطريقة معينة، ولا من أن هذه العملية تجلب لذة.“ وإذا كان هذا قصدهم، فهم على صواب. والمسيحية تقول الشيء نفسه. فالمشكلة ليست في الجنس نفسه ولا في اللّذة نفسها. لقد قال المعلِّمون المسيحيون الأوائل إنه لو لم يسقط الإنسان، لكانت اللّذة الجنسية، بدلًا من أن تكون أقل مما هي الآن، أعظم وأكثر. وأعلم أن بعض المسيحيين المشوّشين تكلموا وكأن المسيحية ترى أن الجنس، أو الجسد، أو اللذة، شرور في ذاتها. لكنهم كانوا مخطئين.
فالمسيحية هي تقريبًا الدين الوحيد بين الديانات الكبرى الذي يوافق تمامًا على الجسد: فهي تؤمن أن المادة خيّرة، وأن الله نفسه قد أخذ جسدًا بشريًا، وأننا سنُعطَى نوعًا من الأجساد حتى في السماء، وسيكون جزءًا أساسيًا من سعادتنا وجمالنا وقوتنا. كما أنّ المسيحية قد مجَّدت الزواج أكثر من أي دين آخر؛ وأغلب أعظم أشعار الحب في العالم كتبها مسيحيون. فإن قال أحد إن الجنس في ذاته شر، المسيحية تعارضه فورًا.
لكن بالطبع، حين يقول الناس: ”الجنس ليس شيئًا نخجل منه“، قد يقصدون: “الحالة التي وصلَت إليها الغريزة الجنسية الآن ليست شيئًا نخجل منه.“
وإن كانوا يقصدون بذلك أن الحالة التي وصلت إليها الغريزة الجنسية اليوم ليست مدعاة للخجل، فأنا أظن أنهم مخطئون. بل أظن أنها كلّها مدعاة للخجل. فليس هناك ما يُخجِل في الاستمتاع بالطعام، لكن سيكون هناك كل ما يُخجِل لو أن نصف العالم جعل الطعام هو شاغله الأساسي في الحياة، يقضي وقته محدِّقًا في صور الطعام، يسيل لعابه، ويُصدر أصوات الشفاه المتلذِّذة.
ولا أقول إنك وأنا مسؤولان بشكل فردي عن الوضع الحالي. فأسلافنا سلّمونا أجسادًا مشوّهة في هذا الجانب؛ ثم نشأنا محاطين بدعاية متواصلة لصالح عدم العفة. وهناك أُناس يريدون أن يُبقوا غريزتنا الجنسية مُلتهِبَة ليجنوْا المال من ورائنا. إذ بالطبع، الإنسان المهووس هو إنسان ضعيف المقاومة أمام الإعلانات والبيع. الله وحده يعرف وضعنا؛ وهو لن يديننا كما لو لم تكن أمامنا صعوبات لنتخطّاها. ما يهم هو صدق الإرادة والمثابرة في محاولتنا التغلب على هذه الصعوبات.
وقبل أن نُشفَى، علينا أن نرغب فعلًا في أن نُشفى. فالذين يطلبون العون بصدق سينالونه؛ أمّا الكثير من الناس في عصرنا، فحتى مجرّد الرغبة في ذلك صارت أمرًا عسيرًا. من السهل أن نُخيَّل لأنفسنا أننا نريد شيئًا ما، بينما نحن لا نريده حقًا. وقد أخبرنا أحد المسيحيين المشهورين منذ زمن بعيد أنه حين كان شابًا كان يصلّي باستمرار من أجل العفّة؛ لكن بعد سنوات أدرك أنه بينما كانت شفتاه تقولان: ”يا رب، اجعلني عفيفًا“، كان قلبه يضيف في السر: “لكن أرجوك، ليس بعد… ليس الآن.“
وقد يحدث هذا أيضًا في صلوات طلب الفضائل الأخرى. لكن هناك ثلاثة أسباب تجعل من الصعب علينا في زمننا أن نرغب – فضلًا عن أن نحقِّق – العفة الكاملة.
أولًا، طبيعتنا المشوَّهة، والشياطين التي تُغوينا، وكل الدعاية المعاصرة للشهوة، تتآمر معًا لتجعلنا نشعُر بأن الرغبات التي نقاومها هي رغبات ”طبيعية“، ”صحيّة“، و”معقولة“، حتى ليبدو لنا أن مقاومتها تصرُّف شاذ أو غير طبيعي. ملصق بعد ملصق، فيلم بعد فيلم، رواية بعد رواية، تربط بين الانغماس الجنسي وبين الصحة، والطبيعيّة، والشباب، والصراحة، وروح الدعابة.
لكن هذه العلاقة المزعومة كذبة. وككُل الأكاذيب القوية، فهي مبنية على جزء من الحقيقة – الحقيقة التي أُقرّت سابقًا، وهي أن الجنس في ذاته طبيعي وصحي وما إلى ذلك. لكن الكذبة تكمن في الإيحاء بأن أي فعل جنسي يُغريك به هواك في لحظة ما هو أيضًا صحي وطبيعي. وهذا، على أي وجه، وبغضّ النظر عن المسيحية، هراء صريح. فالاستسلام لكل رغباتنا يقود بالضرورة إلى العجز، والمرض، والغيرة، والأكاذيب، والتستُّر، وكل ما يعاكس الصحة، وروح الدعابة، والصدق.
ولأجل أي سعادة – في هذا العالم – فإن قدرًا كبيرًا من ضبط النفس أمر لا غنى عنه. ومن ثمّ، فإن الادعاء الذي ترفعه كل رغبة حين تشتد بأنها ”صحيّة“ و”معقولة“ لا يساوي شيئًا. فكل إنسان عاقل ومتحضّر لا بد أن تكون لديه مجموعة من المبادئ يختار على أساسها أن يرفض بعض رغباته ويُجيز البعض الآخر. قد يستند أحدهم إلى المبادئ المسيحية، وآخر إلى المبادئ الصحية، وآخر إلى المبادئ الاجتماعية.
إذن فالصراع الحقيقي ليس بين ”المسيحية“ و”الطبيعة“، بل بين المبادئ المسيحية وغيرها من المبادئ التي تضبط ”الطبيعة“. لأن ”الطبيعة“ – بالمعنى الذي يشير إلى الرغبات الطبيعية – لا بد أن تُضبط على أي حال، وإلا دمّرنا حياتنا تمامًا. والمبادئ المسيحية، بلا شك، أشد صرامة من غيرها؛ لكنها تأتي ومعها معونة إلهية تساعدنا على طاعتها، وهي معونة لا نجدها في طاعة أي مبادئ أخرى.
ثانيًا، كثيرون يعزفون عن المحاولة في العفّة المسيحية بجدية لأنهم يظنون – قبل أن يجرّبوا – أنها مستحيلة. لكن حين يكون هناك أمر لا بد من القيام به، لا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بالتفكير في ”إمكانية” أو “استحالة” الأمر. ففي سؤال اختياري في ورقة امتحان، للمرء أن يتساءل عمّا إذا كان يستطيع الإجابة أم لا؛ أما في سؤال إلزامي، فعليه أن يبذل ما يستطيع. قد تنال بعض الدرجات عن إجابة ناقصة جدًا، لكنك لن تنال شيئًا إن تركت السؤال فارغًا. وليس في الامتحانات فقط، بل في الحرب، وفي تسلّق الجبال، وفي تعلّم التزلج أو السباحة أو ركوب الدراجة، أو حتى في محاولة ربط ياقة متصلبة بأصابع متجمدة، كثيرًا ما يفعل الناس ما بدا لهم من قبل مستحيلًا. إنه أمر مدهش ما الذي يمكن أن نفعله حين يكون علينا أن نفعله.
ويمكننا أن نكون واثقين أن العفة الكاملة – كما المحبة الكاملة – لن تتحقَّق أبدًا بجهود بشرية خالصة. فلا بد أن نطلب معونة الله. وحتى بعد أن نفعل، قد يبدو لنا لوقت طويل أن لا معونة تصل، أو أن المعونة أقل مما نحتاجه. لا بأس. بعد كل سقوط، اطلب الغفران، انهض من جديد، وحاول مرة أخرى. فكثيرًا ما تكون أول معونة يمنحنا الله إياها ليست الفضيلة ذاتها، بل القدرة على الاستمرار في المحاولة. ومهما كانت العفة، أو الشجاعة، أو الصدق، أو أي فضيلة أخرى مهمة، فإن هذه العملية تدرّبنا على عادات نفسية وروحية أعمق وأهم. إنها تخلّصنا من أوهامنا عن أنفسنا وتعلّمنا الاتكال على الله. نتعلّم، من ناحية، أننا لا نستطيع أن نثق في أنفسنا حتى في أفضل لحظاتنا، ومن ناحية أخرى، أننا لسنا بحاجة إلى اليأس حتى في أسوأ لحظاتنا، لأن إخفاقاتنا تُغفَر. إنّ الشيء الوحيد المميت حقًا هو أن نجلس قانعين بما هو أقل من الكمال.
ثالثًا، يُسيء الناس غالبًا فهم ما تعلّمه علم النفس عن ”الكبت“. فهو يعلّمنا أن الجنس المكبوت خطير. لكن كلمة ”مكبوت“ هنا هي مصطلح تقني؛ فهي لا تعني ”مقموع“ بالمعنى البسيط لـ ”مرفوض“ أو ”مقاوم“. إنما الرغبة أو الفكرة المكبوتة هي ما دُفعت إلى اللاوعي – عادة في سن مبكرة جدًا – وأصبحت لا تظهر للعقل إلاّ في صورة مقنّعة وغير قابلة للتعرّف. فالجنس المكبوت لا يظهر للمريض باعتباره جنسًا على الإطلاق. أمّا حين يقاوم مراهق أو شخص بالغ رغبة واعية، فهو لا يتعامل مع ”كبت“، ولا هو في أي خطر من أن يخلق كبتًا. على العكس، أولئك الذين يحاولون العفّة بجدّية يكونون أكثر وعيًا، وسرعان ما يعرفون عن ميولهم الجنسية أكثر من أي شخص آخر. إنهم يتعرّفون إلى رغباتهم كما عرف ولنغتون نابليون، أو كما عرف شرلوك هولمز خصمه موريارتي؛ كما يعرف صيّاد الجرذان الجرذان، أو كما يعرف السباك مواسير المياه المتسربة. الفضيلة – مجرد محاولة الفضيلة – تجلب النور؛ أما التفريط فيجلب التشوش.
وأخيرًا، مع أنني اضطررت للكلام طويلًا عن موضوع الجنس، أود أن أوضِّح بأقصَى قدر ممكن أنّ مركز الأخلاق المسيحية ليس هنا. فإذا ظنّ أحد أن المسيحيين يعتبرون فقدان العفّة هو الخطيئة العظمى، فهو مخطئ تمامًا. خطايا الجسد سيئة، لكنها الأقل سوءًا بين جميع الخطايا. فأبشع الملذّات كلها روحية خالصة: لذة إيقاع الآخرين في الخطأ، لذة السيطرة والتعالي وإفساد فرحة الآخرين، لذة النميمة، ولذّات القوة والبغضاء. في داخلي قوتان تتصارعان مع الذات الإنسانية التي يجب أن أصيرها: الذات الحيوانية، والذات الشيطانية. والذات الشيطانية أسوأ الاثنين. لهذا قد يكون المتديّن البارد، المليء بالبرّ الذاتي، الذي يواظب على الذهاب إلى الكنيسة، أقرب إلى جهنم من زانية. لكن، بالطبع، الأفضل أن لا يكون المرء لا هذا ولا ذاك.
عن كتاب المسيحية المجرّدة
ترجمة جديدة
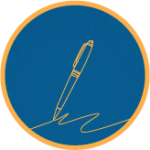

أقسام الأخلاق الثلاثة هناك قصة عن تلميذ في مدرسة سُئل عمّا يظنّه عن الله. فأجاب

إن مشاركة إحتياجات الحياة، هو تعبير عن الوحدة الحقيقة وممارسة للحرية. فهى أفعال الحب المتينة داخل

بنفس المفهوم الغربي، يُعرف الكثير من الناس الكنيسة علي أنها الإكليروس فقط. أى الأساقفة والقسوس